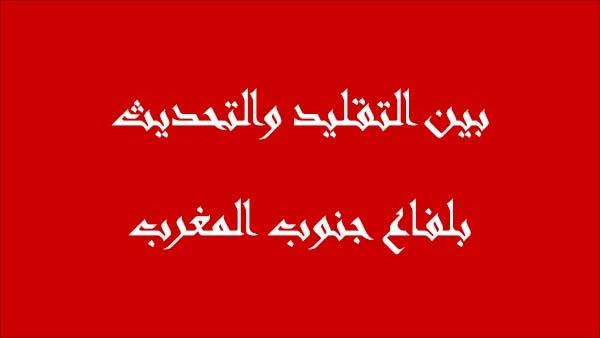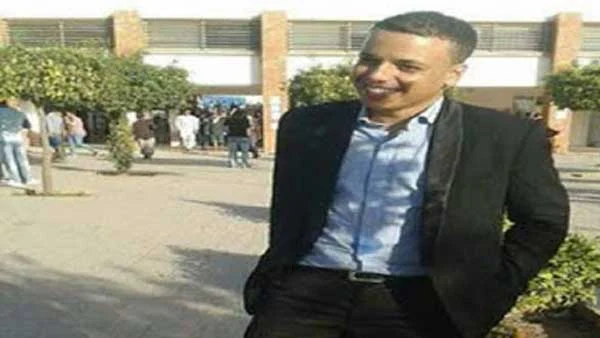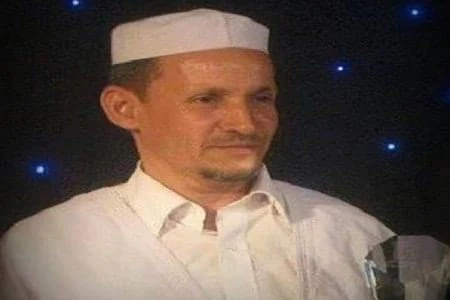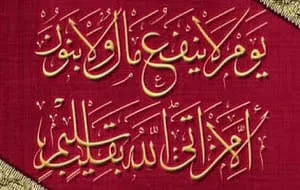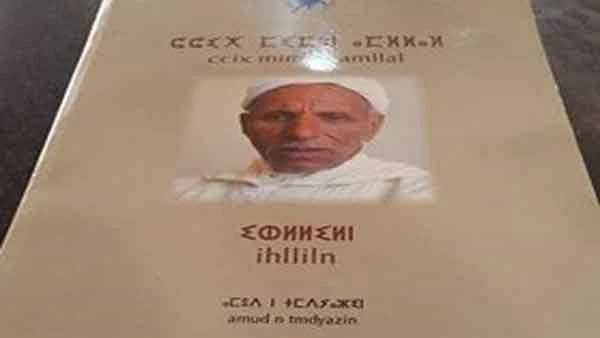إن نمو الخط الفاصل في الواقعية السوسيولوجية بين الدول المتقدمة وتخلف الدول المتخلفة يسمح بالتعرض للمشكلة الرئيسية دون الخضوع في هذا الميدان إلى مفهومين خاطئين وشائعين في آن واحد, أحدهما يدعي أن الدول المتقدمة الحديثة أسيرة ماضيها فقط ولا تقوم في نهاية المطاف إلا بتشخيص مسرحيات درامية عتيقة وبألبسة عصرية.
المفهوم الآخر لتفوق الدول المتقدمة الحديثة يكمن في أن الدول المتقدمة الحديثة قد تخلصت تماما من ماضيها, وما هي إلا وليدة حقبة لا تدين بشئ إلا لنفسها.
تلك مسألة تؤرق الجميع وأرى من واجب الكل معالجة الوضع, فالفجوة الحضارية القائمة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة تزداد تقدما في كل لحظة, لو فرضنا جدلا أننا نتقدم فإن سرعة تقدمنا لا تتجاوز سرعة مسير الذابة, بينما تتقدم الدول المتقدمة الحديثة بسرعة الطائرة أو أكثر.
إضافة إلى تحكم الدول المتقدمة الحديثة في بنياتها الإجتماعية وترك العقل والعلم حرية التسيير والتدبير من أجل بناء صرح مجتمع حداثي وديموقراطي عكس تخبط الدول المتخلفة التقليدية في جلبابها الديني واستعمال السلطة السياسية بشكل دفاعي مغيبين في ذلك المبادئ الأساسية للديموقراطية والتقاطع معها بسيطرة الأقلية على الأغلبية..
إن الصراع من أجل الحصول على الإعتراف والتقدير يتيح لنا نظرة أعمق في طبيعة السياسات الدولية, فالرغبة في الإعتراف التي أدت إلى المعركة الدموية الأصلية من أجل المنزلة بين شخصين متحاربين, تؤدي منطقيا إلى الإمبريالية والإمبراطورية العالمية. والعلاقة بين السادة والعبيد على المستوى المحلي تتكرر بالضرورة على مستوى الدول حيث تسعى الأمم بوجه عام إلى نيل الإعتراف وتنخرط في معارك دموية لفرض السيطرة..
المفهوم الآخر لتفوق الدول المتقدمة الحديثة يكمن في أن الدول المتقدمة الحديثة قد تخلصت تماما من ماضيها, وما هي إلا وليدة حقبة لا تدين بشئ إلا لنفسها.
ما علاقة تقدم ترتيب الدول المتقدمة الحديثة وتراجع الدول النامية المتخلفة؟
لعل أبرز ما يجعلنا ندخل غمار هذه المقاربة السوسيو تنظيمية هو اتساع الهوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة السالفين الذكر سواء من الناحية الإقتصادية أو السياسية أو الفكرية..تلك مسألة تؤرق الجميع وأرى من واجب الكل معالجة الوضع, فالفجوة الحضارية القائمة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة تزداد تقدما في كل لحظة, لو فرضنا جدلا أننا نتقدم فإن سرعة تقدمنا لا تتجاوز سرعة مسير الذابة, بينما تتقدم الدول المتقدمة الحديثة بسرعة الطائرة أو أكثر.
إضافة إلى تحكم الدول المتقدمة الحديثة في بنياتها الإجتماعية وترك العقل والعلم حرية التسيير والتدبير من أجل بناء صرح مجتمع حداثي وديموقراطي عكس تخبط الدول المتخلفة التقليدية في جلبابها الديني واستعمال السلطة السياسية بشكل دفاعي مغيبين في ذلك المبادئ الأساسية للديموقراطية والتقاطع معها بسيطرة الأقلية على الأغلبية..
إن الصراع من أجل الحصول على الإعتراف والتقدير يتيح لنا نظرة أعمق في طبيعة السياسات الدولية, فالرغبة في الإعتراف التي أدت إلى المعركة الدموية الأصلية من أجل المنزلة بين شخصين متحاربين, تؤدي منطقيا إلى الإمبريالية والإمبراطورية العالمية. والعلاقة بين السادة والعبيد على المستوى المحلي تتكرر بالضرورة على مستوى الدول حيث تسعى الأمم بوجه عام إلى نيل الإعتراف وتنخرط في معارك دموية لفرض السيطرة..
- مع مرور التاريخ، تطورت الأساليب وأصبحت الحاجة أكثر إلحاحا إلى استعمال العقل والسير وراء المعرفة لأن هذه الأخيرة هي الكفيلة من أجل خلق الإستثناء والبروز في الواجهة ومواكبة العصر الحديث.
- الكل على علم أن الفجوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة تتزايد سعة وعمقا كلما تقدم الزمن, وتتضاعف كلما تقدم التاريخ مما يؤدي إلى زيادة تحكم الآخر بمقدرات الدول المتخلفة التقليدية وسيطرتها على مواردها وبالتالي على كيانها بل وجودها، آنذاك تهدر إنسانية الفرد أو الجماعة أو الشعب بأكمله, وأستحضر قولة الرفيق إميل توما في هذا السياق حيث أطلق على الظاهرة لطم الخدود وشق الجيوب..